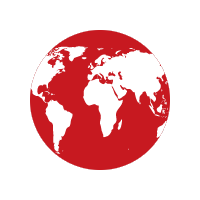بقلم: بشار اللقيس
في البدء كان النيل. لو لم يكن النيل لما كانت مصر. لم يكن النيل منبع الفنون ومبعث حضارة المصريين فحسب. لهذا النهر أثره وخطره. بالنسبة للدولة، إن وجود النيل شرط ضروري لوجود الأمة لكنه شرط غير كافٍ. إن نمط الإنتاج الزراعي الذي يجعل من مصر كياناً حضارياً هو نفسه الذي يحول دون تحقيق وحدتها كدولة وأمة. واقع الأمر، يندر أن يحدّثنا التاريخ عن مجتمع زراعي كافح كأمّة لتحقيق وحدته السياسية. إن على المجتمعات المزارِعة الاختيار دائماً بين أن تكون دولة في حال تعرضها للغزو، أو أن تكون أمة زراعية مستقرة، لكنها مهددة بأصل وحدتها السياسية. ستُلقي هذه المسألة في مصر الحديثة بتركتها الثقيلة على وعي النخبة الحاكمة، كما على علاقة النخبة بالمجتمع. إلى حد كبير تبدو مصر منقسمة، بين وجودها كدولة ووجودها كأمة، أقلّه منذ فترة محمد علي إلى اليوم. كلما طغت السياسة فيها افتقد المجتمع فاعليّته، وكلما استعاد الأخير مجاله نازع السلطة وجودها. يشعر المجتمع أن السلطة جزء منه، وهي تراه خارجاً عنها.
ستؤسس هذه العلاقة الملتبسة بين الدولة والمجتمع لشِرطة بالغة التعقيد. من غير السهل على المجتمع المصري أن يفوض السلطة صلاحيات مطلقة. في الآن عينه، من غير الوارد أن تعترف السلطة بنظام سياسي يكون للشعب فيه حق ممارسة رقابته المطلقة. تمتلك مصر نظاماً حزبياً ضعيفاً مقارنة بعدد من الدول العربية، ويمتلك الرئيس فيها أقوى صلاحيات داخلية مقارنة برؤساء عرب آخرين. لقد نشأت السلطة السياسية في المرحلة الممتدة ما بين فترة اللورد كرومر؛ المندوب السامي البريطاني أواخر القرن التاسع عشر، واللورد كيلرن؛ المندوب البريطاني أواسط القرن العشرين. وهي القترة التي شهدت حربين عالميتين. إن تلك الفترة الاستثنائية التي أعطت مصر لبوسها السياسي صارت، وللمفارقة، قاعدة الممارسة السياسية وصولاً لزماننا اليوم.
لقد أفضت هذه الحياة السياسية لعلاقة مركّبة بين السلطة وطبقتها المنتِجة. لا تمر العلاقة بين السلطة والمجال العام من خلال مشروعية الاقتراع فحسب. إن صندوقة الاقتراع ليست شرطاً كافياً للمشروعية، وقد تكون في أحسن أحوالها مدخلاً لقبول السلطة في شكلها الأولي لا أكثر. إن الفارق بين نجاح تجربة جمال عبد الناصر ما قبل نكبة 67 وفشل تجربة محمد نجيب، لم يكن مرتبطاً بمشروعية الانتخاب البتة. يكمن الفارق بين الرجلين في فهم العلاقة بين الداخل والخارج وأن أي مسألة داخلية إنما تمر مما وراء الحدود. إن هذا الفارق في الفهم هو الذي أفضى لإقالة محمد نجيب بُعيد أقل من عامين من استلامه السلطة، وهو كذلك الذي أفضى لتجسير المسافة الفاصلة بين السلطة والرأي العام فترة عبد الناصر ما قبل 1967.
حتى قمة منتصف نسيان 1971 في طرابلس الغرب، كان يبدو أن ثمة سلطة متماسكة في مصر، وأن توازناً مقبولاً لم يزل قائماً بين أجنحة السلطة. لكن تفرد السادات داخل السلطة بُعيد تلك القمة صار يُنذر بما لا تُحمد عقباه. في القمة التي حضرها حافظ الأسد مضافاً للعقيد القذافي، فاجأ السادات العالم بتوقيعه اتفاق اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة. لعدد غير قليل من المسؤولين المصرين بدا أن السادات يحاول إعادة انتاج السلطة من خلال مشاريع عابرة للحدود وللقيود. كان معنى ذلك أن قواعد السلطة، على الأقل في الجزء السياسي منها، قد تطرأ عليها تغييرات تمس صلب موازينها. في مذكرة سامي شرف، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، بتاريخ العشرين من نيسان 1971، بدا أن ثمة مخاوف لدى القوات المسلحة من سياسات السادات الداخلية. لقد بدأ السادات إعادة انتاج السلطة، وهو ما سيدفع تدريجياً لانفكاك الكتلة المنتجة للسلطة عن السلطة نفسها. ينقل هيكل في نقاش له مع أنور السادات في استراحة في أسوان، في الثاني من نيسان من العام 1975، سؤالاً ما انفك يراوده حول علاقة السلطة في مصر بالقوى المنتجة لها. قال هيكل: إن أي نظام في الدنيا يمثل ويستند إلى قوى اجتماعية معينة، فما هي القوى التي يستند إليها النظام الآن؟ آنذاك، كان السادات مراهناً على القوة الخامسة؛ الجيش. لكن رهان السادات نفسه أفل، ويا للغرابة، على يد بعض من أبناء المؤسسة العسكرية نفسها.
لقد عبّرت حادثة اغتيال السادات ومن قبلها انتفاضة الخبز عن شرخ داخل أجنحة السلطة. إن انفجار الشارع في العام 1977، في ما عُرف بـ «انتفاضة الخبز»، لم يكن مسألة اقتصادية فحسب. لقد عبرت تلك الانتفاضة عن عميق أزمة السلطة السياسية وعجزها عن تعريف هويتها. لم يكن المنتفضون في القاهرة يومئذ من المهمّشين أبداً، لقد كانوا من ضمن الفضاء الحيوي للسلطة ومؤسسات رقابتها. لم يمتلك السادات في ما وصل إليه آنذاك غير التفسير البوليسي للتاريخ والقول بأن ثمة مؤامرة. أما الحقيقة، فهي أن السادات أسس من خلال مسار كامب دايفيد لبداية الشقاق بين أجنحة السلطة. بتوقيعه لاتفاقية كامب دايفيد في العام 1979، ومن قبلها طرد المستشارين السوفيات، هو كان قد حسم أموره في إعادة إنتاج النظام من خلال قضاياه الخارجية. لقد أفقدت سياسات السادات مصر دورها الطبيعي في موقعها وموضعها، وهو ما سيتبدى من خلال شلّه القيادة الاشتراكية.
واقع الحال، ثمة نطاقان حيويان بالنسبة لأي سلطة في مصر لا بد من حفظهما؛ الأول في إفريقيا، والآخر على طول امتداد شرق المتوسط في آسيا. ولأن حزام الصحراء الكبرى يطوّق مصر من الجنوب الغربي ومن الغرب، لم يبق لمصر من افريقيا غير أمن حوض النيل، وهو ما تحرص القاهرة على تأمينه والهيمنة عليه وصولاً حتى مناطق أعالي النيل الأزرق على الحدود مع اثيوبيا. أما في الساحل الشرقي للمتوسط فيبدو أن ثمة مناطق ثلاث تختصر ثلاث قضايا. خط بئر السبع غزة، ويعتبر خط الدفاع الأول عن القاهرة، وهو خط المواجهة أيضاً بين الجيش الثاني المصري والإسرائيليين في العام 1948. خط حمص معرة النعمان، ويمثل مناطق السهوب التي تفصل بين جبال الأقليات في شرق حوض المتوسط. ثم خط حلب لواء الاسكندرونة، ويمثل ثالث خطوط دفاع القاهرة في مواجهة تحديات الغزو الكبرى القادمة ثاني قوة مائية متوسطية؛ تركيا.
إن القاهرة بالمعنى الجيوبوليتيكي مدينة آسيوية في افريقيا، أكثر منها مدينة إفريقية. كما أن أمنها هو أولاً وآخراً هو مسألة آسيوية أكثر منه مسألة إفريقية. لجمال حمدان مقولة في تحليله شخصية مصر. إن المنطقة الممتدة من لواء الاسكندرون إلى لواء الاسكندرية هي منطقة جيوسياسية واحدة. في ميدان محمد علي في القاهرة ثمة نصب للأخير يشير بيده إلى الشرق. إن شرق المتوسط منطقة مجال حيوي مصري، واسرائيل ككيان ما كان ليكون لولا حاجة بريطانيا وفرنسا أواخر القرن التاسع عشر لكيان يحول دون تمدد مصر في المنطقة الآسيوية. إن كل من يريد أن يفهم وظيفة الكيان الصهيوني عليه أن يراجع مراسلات روتشيلد بالميرستون في آب من العام 1840. لقد صرح روتشيلد بالحرف، أن مصر وحدها القادرة على القيام بدور مؤثر في توحيد العرب بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. لذا فإنه يتحتم حجز مصر في موقعها وعدم السماح بخروجها إلي المشرق. وإذا ما استطاع اليهود إنشاء مستعمرات كافية وقوية في فلسطين، فإن هذه المستعمرات تستطيع أن تقوم بمهمة حجز مصر في أفريقيا.
إن هوية السلطة في مصر لا تتحدد بمقتضيات الداخل ومجاله وحده. ثمة مجال حيوي للدولة يتحدد بمقتضى التوازنات الخارجية. وقد لا يصحّ للسلطة مهما تعاظمت أن تخل بتوازن هذين المجالين. في كل مرة أخلّت الدولة بشرائط الخارج وتوازناته أفضت الأحوال في ما بعد لسقوط رأس هرم السلطة. ذلك ما حصل مع محمد نجيب وأنور السادات ومحمد مرسي بشكل أو بآخر. لقد عوّل مرسي، شأنه شأن محمد نجيب على قوة التفويض الداخلي وأخلّ بتوازنات الأحزمة الثلاثة الخارجية. في غزة والشأن الفلسطيني هادن مرسي معتقداً أن ثمة أولويات أخرى. وبغض النظر عن كل ما قيل عن اقالة مرسي اعتماد مرسي على حزب «الحرية والعدالة» وإقالته لأكثر من 15 محافظاً من متقاعدي القوات المسلحة، فإن خطابه الأخير في استاد القاهرة كان بمثابة إعلان رصاصة الرحمة عليه وعلى التجربة «الإخوانية». في استاد القاهرة دعى مرسي للجهاد في سوريا وهو ما قرأته المؤسسة العسكرية بمثابة اللعب بتوازنات آخر خطوط الدفاع عن القاهرة. إن أمن دمشق من أمن القاهرة، وأي انقسام سيقع داخل الحيّز السوري لا شك سيمتد ليطال القاهرة. تدرك القاهرة جيداً أزمة منطقة شرق الفرات في سوريا، وتدرك جيداً وجه التشابه القبلي والاجتماعي لتلك المنطقة مع شبه جزيرة سيناء. هي أيضاً تدرك أزمات الأقليات وانقسام القطر السوري، وتتطلع بحذر لما يحكى عن استقلال هوية النوبة. لقد كانت تجربة انشقاق جنوب السودان ماثلة في ذهن المؤسسة العسكرية المصرية في العام 2013 أكثر مما يتخيل البعض، وهو ما دفعها للنظر الى تدخل «حزب الله» في الأزمة السورية على أنه انقاذ لأهم خطوط الدفاع عن القاهرة. إن حفظ المقاومة، في لبنان وفلسطين، هو حفظ للقاهرة قبل كل شيء. كما أن حفظ الوحدة السياسية لدمشق هو حفظ للعمق الاستراتيجي للقاهرة ولما تبقى من استقرار في المنطقة.
تخطئ القاهرة اليوم إذا ما اعتقدت أن أمنها يتجاوز مسألة المقاومة. إن غض النظر عن تطاول اسرائيل في الجنوب السوري وفي غزة لن يؤول لخسارة مصر لحافتها المشرقية بقدر ما سيؤول لتطويق اسرائيل للقاهرة نفسها. عشية طرح الرئيس السيسي مبادرة السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية حطّت طائرة بنيامين نتنياهو في اثيوبيا ليلقي نتنياهو الخطاب الأخطر في تاريخ اسرائيل الحديث. لقد تجاوز نتنياهو مرحلة الشراكة مع دول حوض النيل ليتحدث عن وحدة الدم مع اثيوبيا. إن القاهرة مهددة اليوم بشمالها وشرقها مثلما هي مهددة بجنوبها. والرهان على الوقت ينبؤنا التاريخ أنه لم يكن في يوم من الأيام لصالح رأس السلطة في القاهرة. لن تؤمن المسألة الداخلية كامل المشروعية إن لم تتوازى مع مقاربة مختلفة للسياسة الخارجية، وهي إن لم تتنبّه لمنطق التاريخ ومسلماته فمن الكارثة ألا تتنبّه لما تحمله مهادنة اسرائيل من المخاطرة.
عن "السفير" اللبنانية