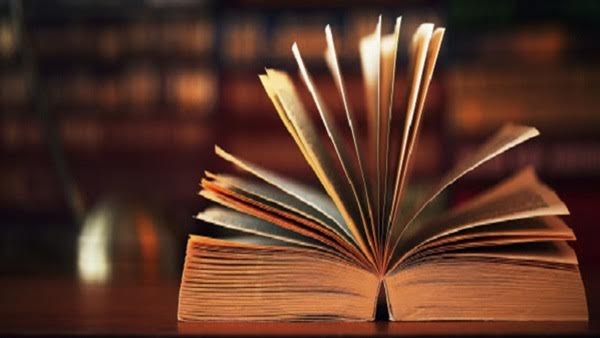سامي حسن
شكلت الثقافة، وما زالت، أحد ميادين وأشكال الصراع مع المشروع الصهيوني وإسرائيل. فالرواية الصهيونية حول الوطن القومي لليهود وحقهم في فلسطين، بنيت على تزوير التاريخ، وتشويه الحقائق، وإبراز اليهود كشعب له ثقافته الجامعة، في مقابل إنكارهم وجود مقومات للفلسطينيين كشعب، وإظهارهم كبشر، بلا هوية، وبلا ثقافة، ومقطوعين عن الحضارة والتاريخ. من هنا كان للمثقفين الفلسطينيين، وبالاستناد إلى الحجج المعرفية والعلمية، دورهم الهام في مواجهة السردية الصهيونية، وتفنيد مزاعمها. وللخروج من حالة الصدمة واليأس والإحباط، التي أصابت الفلسطينيين بعد قيام إسرائيل، ومن أجل معالجة تداعيات النكبة عليهم وعلى هويتهم، كان لا بد للمثقف الفلسطيني أن يأخذ دوره، في نشر الوعي، وشحن الهمم، وزرع الأمل وروح المقاومة، في صفوف الفلسطينيين، والمساهمة في إعادة بناء الهوية الوطنية والقومية للفلسطينيين، وتعزيزها والدفاع عنها. لا شك أن المثقفين هم بشر مثل غيرهم، وقد أصابهم ما أصاب الفلسطينيين عامة من يأس وإحباط. لكن ميزة المثقف الحقيقي، هي استيعاب الصدمات، واستلهام العبر والدروس، ورفض الرضوخ للواقع، وإنارة طريق التغيير.
إن الاهتمام الذي تبديه إسرائيل حيال الثقافة، والدعم الكبير الذي تقدمه لمؤسساتها الثقافية والتعليمية والأكاديمية والبحثية، يدل على أهميتها في تدعيم الدولة الصهيونية، وعلى الحيز الذي تحتله الثقافة في الصراع. الأمر الذي يفسر ما تقوم به إسرائيل من حرب على الثقافة الفلسطينية وتدمير لمؤسساتها، واغتيال للمثقفين الفلسطينيين. فلم يكن عبثاً إسرائيليا، اغتيال غسان كنفاني ووائل زعيتر وحنا مقبل وكمال ناصر وماجد أبو شرار وغيرهم. إن ما يقدمه المثقف الفلسطيني من إبداعات ثقافية، فكراً، وشعراً، ورواية، ومسرحا، وسينما وفنا تشكيليا، يساهم ليس فقط في تعميق وعي الفلسطينيين، بل وفي إيصال صوتهم إلى العالم، وتأكيد، أن هذا الشعب، مثل كل شعوب الأرض، يستحق الحياة ويستحق الحرية. ومن نافل القول، إن الثقافة الرديئة، التي تكني نفسها بالمقاومة هي ثقافة لا تخدم المقاومة. فكي تكون الثقافة مقاومة، ومؤثرة، يجب أن تكون نتاجاتها مبدعة، وأن تتميز بالعمق والجمال والإنسانية.. فلو لم يكن شعر محمود درويش عميقاً وعذباً وإنسانياً، لما وجد طريقه إلى قلوب الناس. ولو لم تكن كتابات إدوارد سعيد، كشفاً معرفيا، لما أثارت كل هذا الجدل. لو لم يكن الإبداع حاضراً وبقوة في "المتشائل" لاميل حبيبي و"رجال في الشمس" لغسان كنفاني و"باب الشمس" لإلياس خوري، لما تحولت الأولى إلى عمل مسرحي والثانية والثالثة إلى أعمال سينمائية. لو لم تكن كاريكاتيرات ناجي العلي ثاقبة ومعبرة لما حركت عقولنا ومشاعرنا. ولو لم تكن لوحات اسماعيل شموط ساحرة لما سحرت أبصارنا.
ينطبق على المشهد الثقافي الفلسطيني ما ينطبق على غيره، عربياً وعالمياً. من حيث تأثره بالحياة الديمقراطية وطبيعة السلطات الحاكمة. فكلما كان الحراك السياسي والمجتمعي قوياً كان الحراك الثقافي متطوراً. لذلك، كان لانطلاق الثورة الفلسطينية في العام 1965، وتنامي دورها وقدراتها، واتساع حضورها في المجتمع الفلسطيني والعربي، انعكاساته على المشهد الثقافي الفلسطيني في مختلف مجالاته وفروعه. فتأسست الاتحادات المختلفة من اتحاد الكتاب والصحفيين إلى اتحاد الفنانين التشكيليين، والفرق الفنية، والمجلات والمراكز البحثية. فجال الشعر في أزقة المخيمات، وغطت الملصقات جدران بيوتها. وأقيمت الأمسيات الأدبية، والندوات الفكرية، والمعارض الفنية، والعروض الغنائية والمسرحية، وعمت السجالات والنقاشات، وصدرت الأبحاث والدراسات. وكان لكل ذلك، دوره التوعوي والتعبوي، وساهمت نتاجات المثقفين الفلسطينيين وإبداعاتهم في ترسيخ الهوية الوطنية وإغنائها، وفي كسب المؤيدين للنضال الفلسطيني، من كل أنحاء العالم. وسواء كان تفعيل المشهد الثقافي الفلسطيني، قد جاء في سياق رغبة الممسكين بالحركة الوطنية الفلسطينية، أم رغماً عنهم، إلا أن ما تجدر ملاحظته، هو أن تمركز المقاومة الفلسطينية في الشتات، وغياب الدولة والسلطة، قد أعطى هوامش للمثقفين الفلسطينيين، على صعيد حرية الرأي والتعبير، والنقد وقول الحقيقة، أوسع مما أتيح لأمثالهم في الدول التي حكمتها أنظمة مستبدة.
في العام 1982 اجتاحت إسرائيل لبنان. وقد ساهم المثقفون الفلسطينيون والعرب، من خلال وسائل الإعلام المتعددة، بالكلمة والصوت واللوحة، في تعزيز صمود المقاومة الفلسطينية اللبنانية، في وجه الاجتياح. وعلى رغم تدمير البنية التحتية لمنظمة التحرير، و خروج المقاومة من لبنان، إلا أن المشهد الثقافي الفلسطيني، بقي، إلى حد لا بأس به، محافظاً على حيويته. وجاءت انتفاضة الحجارة في العام 1987 لتساهم في تفعيل ذلك المشهد، وزج المثقفين في أتون الانتفاضة التي استعجلت القيادة الفلسطينية قطف ثمارها، فكان مؤتمر مدريد ومن ثم اتفاق أوسلو الذي أرخى بظلاله القاتمة على المشهد الثقافي الفلسطيني. حيث أحدث ذلك الاتفاق، المبني على تجزئة القضية والأرض والشعب، شروخاً عميقة في المشروع الوطني الفلسطيني، وأدى إلى تهميش دور الشتات ودور مؤسسات منظمة التحرير، بما في ذلك، الثقافية منها. وغير اتجاه بوصلة المعركة الثقافية مع الدولة الصهيونية، ومنح الشرعية لها ولسرديتها. وكما هو حال السلطات العربية الحاكمة، فقد ركزت السلطة الفلسطينية الوليدة على بناء الأجهزة الأمنية، وخصصت لها ميزانيات كبيرة، بينما أهملت المؤسسات الثقافية والتعليمية، وضيقت على المثقفين المعارضين لها ولنهجها وسياساتها. وتكرر الأمر نفسه، عندما سيطرت حماس في العام 2007 على السلطة في قطاع غزة، وزادت عليه، مساعيها لأسلمة الثقافة الفلسطينية، وتفريغها من سماتها الوطنية، محولة الصراع مع إسرائيل إلى صراع ديني. فضلاً عن ذلك، فقد وقعت الثقافة الفلسطينية، ضحية اعتماد سلطتي رام الله وغزة على الولاء بدلاً من الكفاءة كمعيار لاختيار العاملين في المؤسسات الثقافية. ما أدى إلى ضعف الأداء الثقافي، وهزالته، شكلاً ومضموناً. ولنا في المشهد الإعلامي البائس والباهت الذي تتحفنا به الفضائيات التابعة لكلتا السلطتين مثال على ذلك!!
يبدو جلياً اليوم، أن المهيمنين على النظام السياسي الفلسطيني، يتحملون مسؤولية كبيرة عن تراجع دور الثقافة وتدهور أحوال المؤسسات الثقافية الفلسطينية. من هنا، فإن إعادة إحياء المشروع الثقافي الفلسطيني، وبناء مؤسساته، يتطلبان إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته على أسس صحيحة ووفق استراتيجية واضحة تنطلق من رفض أوسلو وتداعياته، ومن وحدة القضية، أرضاً وشعبا، ومن التأكيد على جوهر الصراع، وطبيعة المشروع الصهيوني، والتمسك بالثوابت والحقوق الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني كمشروع تحرري ديمقراطي إنساني يهدف إلى الخلاص من الاحتلال الاستيطاني وإقامة الدولة الديمقراطية. لكن، هل ينتظر المثقف الفلسطيني تحقيق ذلك، أي إعادة بناء نظامه السياسي، كي يمارس دوره في الصراع؟ بالطبع لا. يقول جميل هلال: "أضحى الشعب الفلسطيني اليوم بلا دولة ذات سيادة وبلا حركة تحرر وطني. ومع ذلك، تملك الوطنية الفلسطينية حيوية متميزة، ويعود الفضل في ذلك إلى دور الحقل الثقافي في الحفاظ على الرواية الفلسطينية وإثرائها" ويمكن الإضافة والقول، إن عملية إعادة البناء التي أشرنا لها، ربما تتطلب مبادرة المثقفين إليها، وربما، لا يمكن إنجازها، بمعزل عنهم. وبحسب ادوارد سعيد: "فلم يحدث أن قامت ثورة كبرى في التاريخ الحديث من دون مثقفين، وفي مقابل ذلك لم تنشب حركة مناهضة كبرى للثورة من دون مثقفين". إذن، فالمثقف الذي نتحدث عنه، ونعول عليه، في صراعنا مع عدونا، وفي إعادة بناء نظامنا السياسي، هو ما يطلق عليه "المثقف المشتبك" الذي يمارس دوره مهما كانت الظروف، ومهما بلغ من الإحباط، فتكوينه الفكري والنفسي، وربما قدره، يدفعه إلى ذلك. إنه المثقف المستقل عن السلطة، المشتبك معها، الرافض لامتيازاتها وإغراءاتها، هو "المثقف العضوي" وفق تعبير غرامشي، المنحاز لشعبه، ولغيره من الشعوب، في معارك الحرية والتحرر والعدالة والمساواة. هو المثقف النقدي، الذي ينطق بالحق والحقيقة، وإذ يستعصي عليه ذلك، لسبب أو لآخر، لا يلجأ، كما هو حال بعض المثقفين، إلى التزييف، أو التبرير بالقول، إنهم مثقفون لا شأن لهم بالسياسة! فهذا القول هو بحد ذاته موقف سياسي، وتدخل بالسياسة. إذن، إن تدخل المثقف بالسياسة، وهو واجب، واقع بطبيعة الحال، سواء أراد المثقف ذلك ووعاه أم لا. المهم أن لا يكون تدخل المثقف لصالح السلطة والسلطان. وأن لا يقوم المثقف بإلحاق أو استبدال عمله الثقافي بالسياسي، فالثقافة على حد تعبير ياسين الحاج صالح هي "قوة سياسية بما هي ثقافة".
العربي الجديد