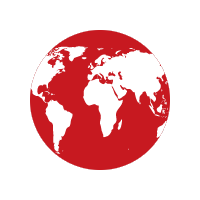سجود عوايص
محتويات
كيف صاغت الصهيونية خريطة التهجير شرقًا؟ “الجار البعيد خيرٌ من العدو القريب“يوسف فايتز: “مهندس الترانسفير الأول”ترانسفير بنَفَس طويل: أرض أكثر، عرب أقلخريطة بلا غزّاويين
مما يُروى في تاريخ الحركة الصهيونية، أن الحاخام اليهودي لمدينة فيينا أراد أن يتأكد من أهلية فلسطين لاستقبال اليهود، استجابة لما طرحه ثيودور هيرتزل في كتابه “دولة اليهود”، وما نوقش في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عُقد في بازل عام 1897، حول “خلو فلسطين وفراغها من السكان”، فأرسل مبعوثين عنه للتحري عن أوضاع البلاد.
وكما تبيّن لاحقًا، أثبتت فلسطين جدارتها في أعين المبعوثين؛ أرضٌ جميلة، عامرة بالخيرات، لكن مشكلة واحدة فقط كانت تقف في وجه أفكار هيرتزل وأحلام الحاخام، اختزلها مبعوثه في جملة واحدة، أرسلها في برقية شهيرة: “العروس جميلة، لكنها متزوجة من رجل آخر!”
في الواقع، لم تكن الصهيونية بحاجة لأكثر من “العروس”، أما “الرجل الآخر”، فقد تُرك لذهنية منظّريها ومفكّريها ليبتدعوا الحيل والمفاهيم على مسارين: أولًا، نفي وجوده، وإزاحته من السردية عبر خطاب متكرر عن “أرض بلا شعب”، يمهّد للهجرات اليهودية من حول العالم لتسير بسلاسة ويُسر.
وثانيًا، إزاحته الفعلية، بالاقتلاع والطرد و”الترانسفير”، الذي ظلّ حاضرًا في المخيال الصهيوني، تغذّيه مبررات الجغرافيا والديموغرافيا والأمن، وتُكرَّر حتى يومنا هذا؛ فـ”إسرائيل” لا تشغل سوى أقل من 1% من مساحة العالم العربي، وهناك دائمًا – وفق منطقهم – متسع للفلسطينيين بعيدًا عن أرضهم.
من الخيال إلى الحسم، تتبع هذه السطور تاريخ الترانسفير الإسرائيلي؛ من بداياته الصامتة حتى صراخه الحالي، من “التشجيع” إلى “القسر”، ومن “الطوعي” إلى “العسكري”، من هيرتزل إلى سموتريتش، وهذه المرة بدعمٍ دولي، وصمتٍ عربي، وإبادة حتى التهجير.
كيف صاغت الصهيونية خريطة التهجير شرقًا؟
في عام 1992، أظهر استطلاع للرأي أُجري داخل الشارع الإسرائيلي أن نحو نصف الجمهور الإسرائيلي يدعم طرد العرب، ويؤيد إخراجهم وإبعادهم، سواء بطرق “طوعية” أو قسرية، واللافت أن هذا الاستطلاع جاء في وقت لم تكن فيه الأحزاب اليمينية الإسرائيلية تحظى بأكثر من 15% من أصوات الناخبين.
وفي العام نفسه، كانت مداولات اتفاق أوسلو على أشدها بين الجانب “الإسرائيلي” ومنظمة التحرير الفلسطينية، التي وجدت فيه موطئ قدم في فلسطين، واعتبرت أن “غزة وأريحا أولًا” هي البدايات، أما النهايات فعبّر عنها ياسر عرفات ذات يوم بقوله: “سيأتي يوم ويرفع فيه شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق كنائس القدس، ومآذن القدس، وأسوار القدس الشريف”.
لكن البدايات التي صاغتها أوسلو، والنهايات التي سعى لها الإسرائيليون حتى من خلال الاتفاق نفسه لم تكن ناتجة عن مفصل سياسي معين داخل النظام “الإسرائيلي”، ولا عن رد فعل فلسطيني معين تجاه الاحتلال وسياساته، بل هي سابقة للنكبة والنكسة، وسابقة لبتسلئيل سموتريتش وموشيه ديان، ولانتفاضة الأقصى وطوفان الأقصى، بعقود طويلة.
ففي كتابه الأول، “طرد الفلسطينيين: مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيونيين 1882–1948″، الصادر عام 1992، قدّم المؤرخ الفلسطيني نور مصالحة إثباتات موثقة من الأرشيف الإسرائيلي لفترة ما قبل نكبة 1948، تؤكد أن فكرة الترانسفير والتهجير لم تكن مجرد خيار طارئ، بل ركنًا أصيلًا في الفكر الصهيوني، وتعود بالنسب إلى منظّريه، والتنفيذ إلى قادته المشرفين عليه.
أما كتابه الثاني، “أرض أكثر وعرب أقل: سياسة الترانسفير الإسرائيلية في التطبيق 1949–1996″، فقد حظي بانتشار واسع، وأكد أن هذا النهج الذي ظن العرب والفلسطينيون أنه انتهى مع أوسلو ما زال قائمًا، مستمرًا ومتطورًا في أدواته، لكنه ثابت في جوهره، ومجمعٌ عليه في المخيال الصهيوني.
التسلسل الذي يعرضه كتابا نور مصالحة لبداية التهجير، يبدأ من “المعلم الأول” في المحفل الصهيوني، ثيودور هرتزل، الذي وجد في نظرية “الفراغ الحضاري” بوابةً لتشجيع الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، ففي عام 1895، طرح هرتزل فكرة “إعادة التوطين”، مستخدمًا لغة ناعمة تُخفي الهدف الحقيقي، حين كتب: “نقوم بنقل السكان الفقراء بهدوء خارج الحدود، ونوفّر لهم فرص عملٍ في البلدان الجديدة، بينما نحرص على منعهم من العودة والعمل”.
السلاسة التي طرح بها هرتزل نظريته عن الفراغ الحضاري وإعادة التوطين جذبت المنظّرين الصهاينة، ودعتهم إلى زيارة فلسطين للتعرّف على ما اعتبروه “مساحات فارغة تنتظر الاستزراع اليهودي”.
لكن الواقع كان صادمًا: فقد واجه هؤلاء المنظّرون كثافة سكانية فلسطينية عالية، كشفتها زيارتهم الاستكشافية عام 1901، بعيد المؤتمر الصهيوني الأول، ما دفع الكاتب اليهودي البريطاني، يسرائيل زانغويل، إلى الاعتراف قائلاً: “في ولاية القدس وحدها، الكثافة السكانية تبلغ ضعفي نظيرتها في الولايات المتحدة”.
إزاء هذا الواقع، اتجه الصهاينة إلى المعول الأول: الدعاية. فرُوّجت مقولة زانغويل الشهيرة: “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”. وتبع ذلك العمل الميداني؛ إما عبر الهجرة اليهودية، أو عبر التهجير القسري لاحقًا.
اللافت هنا أن زانغويل قدّم للمخيال الصهيوني معولين أساسيين لهدم الوجود الفلسطيني، ما زالت “إسرائيل” تعتمد عليهما حتى اليوم:
المعول الأول هو مقولة “أرض بلا شعب…”، التي لم تكن تعني غياب السكان فعليًا، بل هدفت إلى نزع صفة الحضارة والتطور عن الفلسطينيين، وتوصيفهم بأنهم “قبائل عربية بدوية”، كجزء من بناء مبرر أخلاقي لاحق لاقتلاعهم من البلاد، وقد عبّر زانغويل عن هذا التوجه بصراحة حين قال: “يجب إزالة عقبة الوجود العربي الفلسطيني من البلاد”.
أما المعول الثاني، فكان قائمًا على الفكرة الآتية: العرب يملكون العالم العربي بأسره، بينما اليهود لا يملكون سوى أرض “إسرائيل”، وقد عبّر زانغويل عن ذلك بمنتهى الاستخفاف حين قال: “أليست جزيرة العرب، ومساحتها مليون ميل مربع، كلها لهم؟ ليس ثمة ما يدعو العرب إلى التمسك بهذه الحفنة من الكيلومترات في فلسطين؛ فمن عاداتهم وأمثالهم المأثورة طيّ الخيم والتسلل، فلندعهم الآن يعطون المثل على ذلك”.
رغم سذاجة المقولة وانقطاعها عن المنطقين التاريخي والقانوني، إلا أنها حققت اختراقًا ملحوظًا في العقلين العربي والغربي، بل وأصبحت أيقونة متكررة في خطابات بنيامين نتنياهو، خصوصًا عند حديثه عن “المحور المعتدل” ومستقبل “التطبيع الإبراهيمي”، بقوله: “إسرائيل إحدى أصغر الدول على سطح الأرض من حيث المساحة، ولا تمثل أكثر من 1% من العالم العربي”.
ينسجم هذا الخطاب مع تصريحات دونالد ترامب، وعدد من القادة الغربيين الذين كرّروا بدورهم الحديث عن “مساحات كثيرة فارغة” في الدول العربية يمكن للفلسطينيين العيش فيها.
لكن بعيدًا عن هذه السردية المُضلِّلة، كان العمل الصهيوني لتغيير الواقع السكاني جاريًا على قدم وساق منذ بدايات القرن العشرين، لكنه اصطدم بحائط الواقع السياسي والإداري في نهاية القرن التاسع عشر، حيث لم تكن للحركة الصهيونية مطلق الحرية في ظل السيطرة العثمانية على فلسطين وبلاد الشام، لذا انصبّ تركيزها حينها على الهجرة اليهودية وشراء الأراضي، لتأمين موطئ قدمٍ للمهاجرين.
ومع بداية الانتداب البريطاني، بدأت المرحلة الأكثر جرأة من المشروع؛ إذ أُطلق العنان لمخططات الطرد والتهجير، خاصة بعد وعد بلفور عام 1917، الذي تجاهل تمامًا أي ذكر للسكان العرب في فلسطين، وكأنهم غير موجودين.
وبحسب ما يورده نور مصالحة، فقد كانت الحركة الصهيونية، رغم حرصها على تنفيذ مخططاتها بوسائل ناعمة، تعمل في الظل، بينما ظهرت الأيدي البريطانية في الواجهة، فقدّمت بريطانيا الدعم لعمليات شراء الأراضي، واستُخدمت مقاومة الفلسطينيين للهجرة اليهودية كمبرر لـ”اقتلاع” الفلاحين وهدم بيوتهم، إضافة إلى إصدار قوانين مُمنهجة مثل قانون تسجيل الأراضي عام 1928، وقانون “الأرض الموات”، لانتزاع ملكيات الفلسطينيين وتحويلها لصالح الوكالة اليهودية، ودفعهم قسرًا بعيدًا عن أراضيهم.
من المهم الإشارة هنا إلى أن نهج التنفيذ الناعم لم يكن محل إجماع داخل الحركة الصهيونية؛ إذ برز تيارٌ تصحيحي قاده، زئيف جابوتنسكي، دعا إلى الاستقلال التام عن الإدارة البريطانية، وتنفيذ مخططات الاستيلاء على أرض فلسطين، وإخضاع سكانها العرب بقوة السلاح، لا بالمساومة أو التدرّج.
“الجار البعيد خيرٌ من العدو القريب“
في الفترة الفاصلة بين منتصف العشرينيات ومنتصف الثلاثينيات، بدأ مصطلح التهجير يتردد بصيغ مختلفة داخل المخططات الصهيونية، مثل “الانتقال الداخلي”، و”الانتقالات المحلية”، و”الإزاحات”، وهي مصطلحات تم استخدامها من قبل الإدارة البريطانية لتغيير التموضع السكاني الفلسطيني، بما يُفسح المجال أمام إنشاء مستعمرات يهودية جديدة.
وقد تصاعد هذا المسار مع اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939)، التي شكلت نقطة تحول في الفكر الصهيوني؛ حيث تحوّل مفهوم “الانتقال المحلي” إلى “انتقال إقليمي”، وهو ما نادى به، يسرائيل زانغويل، في وقت مبكر، وتم التعبير عنه في المحاضر الداخلية الصهيونية بمصطلحات مثل: “الانتقال الشامل” و”الطرد”.
ووفق ما كشفته وثائق الأرشيف الإسرائيلي، فإن قادة بارزين كحاييم وايزمان، وديفيد بن غوريون، وموشيه شاريت، قد صادقوا فعليًا على خطط ترحيل الفلسطينيين ابتداءً من عام 1937، ووضعوا هدفًا نهائيًا يتمثل في إفراغ الأرض من العرب الفلسطينيين بالكامل خلال عقدٍ واحد فقط.
وقد أطلق بن غوريون على هذه الخطط مصطلح “غيروتس” – أي الطرد – واختار القوة العسكرية وسيلةً وحيدة لتحقيق هذا الهدف، معتبرًا أن التسوية الحقيقية تمر عبر “التخلّص” من الفلسطينيين لا عبر التعايش معهم.
تزامن مخطط الثلاثة الكبار (وايزمان، بن غوريون، شاريت) مع تحوّل كبير في الموقف البريطاني، الذي كان في السابق يُظهر تفهمًا لـ”حساسية العرب تجاه الهجرة اليهودية”، كما مثّلته لجنة بيل والكتاب الأبي، فقد تبنت اللجنة فكرة تقسيم فلسطين، وطرحت خططًا لـ”نقل سكاني واسع النطاق” تقضي بترحيل 350 ألف عربي من الجليل مقابل نقل 2500 يهودي فقط.
وقد استندت هذه الخطة إلى الطعن في الخصوصية الوطنية للفلسطينيين، كما عبّر عن ذلك وزير المستعمرات البريطاني، أورمسبي غور، حين قال: “عرب فلسطين لا يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، بل جزءًا من سوريا والعالم العربي، وبالتالي لا يوجد عائق أمام نقلهم”.
تُعد لجنة بيل أول اختراق غربي وصهيوني فعلي للموقف العربي الرافض للتهجير؛ إذ نجحت الحركة الصهيونية في إقناع بريطانيا بالضغط على العرب للقبول بخطط “النقل والترحيل القسري”، بدلًا من الضغط على الصهاينة لوقف الهجرة أو منع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
لكن برغم ما مثّلته لجنة بيل من مكسب سياسي للحركة الصهيونية، فإنها لم تكن مرضية تمامًا لها، لا سيّما وأن الإزاحة السكانية التي طرحتها بقيت محدودة ضمن حدود فلسطين نفسها، وهو ما رفضه صراحة بيرل كتسنلسون، مُعلّم بن غوريون ومؤسس حزب ماباي وصحيفة دافار، حين قال: “نقل الفلسطينيين إلى مكان ما داخل فلسطين ليس صحيحًا، أعتقد أن إعادة توطينهم يجب أن تكون في سوريا أو العراق، فالجار البعيد خير من العدو القريب”.
يوسف فايتز: “مهندس الترانسفير الأول”
بحلول عام 1940، أصبح الترانسفير سياسة رسمية، تُعتمد من قبل القيادة الصهيونية، بدءًا من يوسف فايتز، مدير دائرة الاستعمار في الصندوق القومي اليهودي، وانتهاءً بالعصابات الصهيونية وبالهيكل التنظيمي للمشروع الصهيوني،
وعلى الرغم من أن فايتز قضى قرابة عقدٍ من الزمن في تنفيذ “الترحيل الناعم” عبر شراء الأراضي، إلا أنه أعلن فشل هذا المسار، قائلاً بوضوح: “شراء الأراضي لن يجلب لنا دولة. الطريقة الوحيدة هي ترحيل العرب إلى الدول المجاورة. لا يوجد متسع لشعبين، ولا مجال للتوصل إلى تسوية حول ذلك”.
وعلى إثر التقييم الذي أقرّ بـ”بطء نتائج” الأساليب الناعمة، أطلق بن غوريون يد العصابات الصهيونية، في سلسلة من المجازر وعمليات الطرد والترحيل التي بلغت ذروتها مطلع مارس/آذار 1948، من خلال “الخطة داليت”، التي وضعت الأساس التنفيذي لتهجير الفلسطينيين، وتدمير قراهم، واستخدام الإرهاب وسيلة مباشرة لتحقيق الأهداف.
انطلقت تشكيلات الهاغاناه وشتيرن والأرغون والبلماخ في تنفيذ سلسلة من المجازر، شملت اللد والرملة والطنطورة والجليل ودير ياسين، اعتمدت على الرعب والذبح والاغتصاب وبقر بطون النساء، كوسائل لدفع الفلسطينيين إلى ما سُمِّي حينها بـ”الإزاحة خارج الحدود”، وهي التي وصفها بن غوريون في مراسلاته مع قادة العصابات بـ”عمليات مسح سكاني”.
وفي مايو/أيار 1948، أُنشئت لجنة الترحيل بقيادة يوسف فايتز، وضمت ثلاث أذرع رئيسية: الاستخبارات، وإدارة شؤون الشرق الأوسط، والقسم العربي، وكانت مهمتها تنظيم الطرد الجماعي للفلسطينيين، ومنع عودتهم، وتدمير منازلهم، وتوطين المهاجرين اليهود مكانهم، وانتزاع أي ملكية عربية من المشهد.
وإن كان بن غوريون هو العقل المدبر، فإن يوسف فايتز كان أخطبوط التهجير الصهيوني بلا منازع، ورائد الترانسفير الذي رسم تفاصيله بدقة، بل استبق نتائج عام 1948 بوضع برنامج شامل لمنع عودة الفلسطينيين، بدأ بتدمير واسع النطاق للقرى والبلدات العربية، وتغطية أنقاضها بغابات من الأشجار دائمة الخضرة على النمط الأوروبي، في محاولة لمحو آثارها من الجغرافيا والذاكرة.
كما أشرف فايتز على نقل ملكية 250 ألف فدان، وضع الاحتلال يده عليها، من “ملكية دولة إسرائيل” إلى منظمات غير حكومية لا تخضع للمحاسبة القانونية، أبرزها الصندوق القومي اليهودي، في خطوة تهدف إلى إفشال أي مطالب مستقبلية بإعادة الأراضي إلى أصحابها الفلسطينيين، أو الاعتراف بحقهم فيها.
وفي عام 2021، أصدرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC فيلمًا وثائقيًا بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، بعنوان “الصندوق الأزرق“، سلّط الضوء على سيرة فايتز بوصفه “العرّاب” الذي “حوّل صحراء فلسطين إلى غابات إسرائيلية”، و”مهندس الترانسفير الأول”.
يقدّم الفيلم فايتز بصورة إنسانية، باعتباره دعا إلى تعويض اللاجئين الفلسطينيين عن ممتلكاتهم من أجل إسقاط حقهم في العودة، ويلقي باللوم في استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على “تجاهل القادة الإسرائيليين” لاقتراحاته، ما أدى لاحقًا إلى تجدد الاشتباك، واندلاع حرب عام 1967.
ترانسفير بنَفَس طويل: أرض أكثر، عرب أقل
في حرب عام 1967، حصلت “إسرائيل” على فرصة ذهبية للتهجير الجماعي، مكنتها من إخراج أكثر من 116 ألفًا من الجليل الأعلى والجولان، و245 ألفًا من الضفة الغربية، و11 ألفًا من قطاع غزة، خارج الحدود الجديدة، وبينما أعادت تطبيق خطط النكبة في الضفة والقطاع، ابتدعت في الجولان خطة جديدة سُمّيت بـ”خطة المقص”، هدفت إلى تفريغ المنطقة من سكانها عبر حصار مزدوج وقطع طرق العودة.
لكن هذا التوسع الجغرافي، الذي شمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، جاء مصحوبًا بخلل ديموغرافي هائل، وبمسؤولية إدارية ثقيلة تجاه مئات الآلاف من السكان العرب، وهو ما حفّز العقل الصهيوني لإنتاج خطط ترانسفير جديدة تتوافق مع الهدف المركزي: السيطرة على أكبر قدر من الأرض، بأقل عدد ممكن من غير اليهود، ومن أبرزها: خطة ألون، وخطة أشكول، وخطة ديان، التي حملت رؤى مختلفة لتحقيق الهدف ذاته.
وقد اقترح رئيس الوزراء ليفي أشكول تجفيف المياه في قطاع غزة لخلق أزمة إنسانية شاملة، وتدمير ما تبقى من قطاع الزراعة، تمهيدًا لدفع السكان نحو الرحيل، أما وزير جيش الاحتلال موشيه ديان، فتبنّى سياسة تقليص عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، عبر مزيج من الوسائل “الناعمة” و”الخشنة”، واضعًا سقفًا ديموغرافيًا لا يتجاوز 450 ألف فلسطيني (من أصل 350 ألفًا في غزة و600 ألفًا في الضفة آنذاك)، وساعيًا لتحقيق ذلك من خلال الاستيطان الكثيف، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتآكل الهوية الوطنية الفلسطينية، في ما أسماه صراحة بـ”التشجيع على الهجرة”.
ورغم السرية التي أحاطت بهذه السياسات، واعتماد حكومة الاحتلال الإسرائيلية أسلوب الحذر والتدرج، بما في ذلك تقديم منح مالية للفلسطينيين الراغبين في المغادرة، والتنسيق مع دول غربية لاستقبالهم، إلا أن نتائجها العملية كانت محدودة، واقتصرت على تهجير نحو 20 ألف فلسطيني فقط، تم إجبارهم على توقيع تعهدات خطية بعدم العودة إلى الأراضي الفلسطينية.
في الوقت نفسه، واصل الاحتلال تطبيق سياسات تهجيرية غير مباشرة تحت مسمى “الهجرة الطوعية”، من بينها توجيه التخطيط الحضري والقُطري بما يخدم التوسع الاستيطاني اليهودي ويكبح نمو التجمعات الفلسطينية.
ونتيجة لهذه السياسات، تُهدم منازل وقرى بأكملها، ويُجرد الفلسطينيون من ممتلكاتهم، سواء العينية أو المنقولة، بذريعة “الأمن”، كما تُمارس عمليات ترحيل قانونية عبر توظيف “قوانين الطوارئ” و”الأنظمة العسكرية”، لا سيما بحق فلسطينيي القدس والداخل المحتل.
لكن نسبة التهجير ظلت محدودة، رغم تنوع الخطط وتعدد الأدوات، ما دفع قادة الاحتلال لاحقًا إلى تبني مقاربة مختلفة لا تتماشى ظاهريًا مع الطابع التوسعي التقليدي، تمثلت في التنازل عن أقل قدر من الأرض مقابل التخلص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وقد شكّل قطاع غزة العقبة الأولى في هذا السياق؛ إذ عرضت “إسرائيل” على المصريين تولي إدارة غزة ضمن اتفاق كامب ديفيد عام 1978، لكن القاهرة رفضت المقترح.
ثم جاءت اتفاقية أوسلو، المصممة على مقاس خطة ألون (1967)، التي اقترحت تقسيم الضفة الغربية بين الاحتلال والأردن، بحيث يحتفظ الاحتلال بالمناطق الاستراتيجية، بينما تُعهد المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية إلى الإدارة الأردنية.
وقدّمت أوسلو شكلًا جديدًا من التهجير، ليس عبر التقسيم الجراحي، بل من خلال شبكة سيطرة إسرائيلية محكمة على المناطق الحيوية، مع الحفاظ على اتصال جغرافي بين المستوطنات وتشكيل جغرافيا يهودية متصلة بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين، وهو ما جعل الاتفاقية تحظى بإجماع حكومي إسرائيلي واسع عند توقيعها.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى، عاد هاجس الأمن ليطغى، خاصة في قطاع غزة، الذي بات عبئًا أمنيًا وعسكريًا لا يمكن ضبطه، فكان الطرح الأكثر جرأة: الانسحاب من غزة عام 2005، والتخلي عن عدد من المستوطنات مقابل التخلص من عبء السيطرة الأمنية.
ومع ذلك، لم تتوقف مخططات التهجير في القدس، والضفة الغربية، وداخل الخط الأخضر، بل استمرت بوتيرة متصاعدة، وإن بوسائل أكثر “شرعية” ودهاءً، تستند إلى القوانين والإجراءات الإدارية.
خريطة بلا غزّاويين
اليوم، تعود خطط التهجير من جديد، بأوجه “طوعية” وأخرى قسرية، لكن هذه المرة بصوت عالٍ، يردد دونالد ترامب صداه بكل أريحية، بينما تتعطّل أدوات العدالة الدولية، وتصمت الدبلوماسية العربية عن الوقوف في وجهه ووجهها، واللافت أن التهجير المطروح في غزة، يستبق في وعي اليمين الإسرائيلي المتطرف فكرة السيطرة على أرض القطاع، بعدما أثبتت محاولات تطويق الفلسطينيين داخل “غلاف غزة” فشلها مرارًا.
أما في الضفة الغربية، فيحمل بتسلئيل سموتريتش راية التهجير وسلاح الضم، في خطة محلية منظمة: تهجير الفلسطينيين من مناطق “ج” إلى “ب”، ومن “ب” إلى قلب المدن الفلسطينية، مع إحكام الحصار بالمستوطنات والحواجز، ومصادرة الأراضي، وقطع سبل العيش، والقتل العشوائي، وترك الفلسطينيين أمام خيارين لا ثالث لهما: الخضوع أو الهجرة.
ومؤخرًا، بالتزامن مع استئناف الإبادة الجماعية في غزة، أطلقت حكومة الاحتلال دائرة رسمية تُعنى بـ”تهجير فلسطينيي غزة”، تقوم على تسهيل التهجير إلى دول ثالثة، عبر تنسيق داخلي بين الجيش والشاباك والشرطة لتنفيذه ميدانيًا، وتنسيق خارجي مع منظمات دولية ودول أخرى، من أجل إتمام ما تسميه بـ”التهجير الطوعي المنضبط والآمن”.
تنسجم هذه الدائرة مع خطة ترامب لغزة الريفييرا، التي لا يرى فيها غزّاويًا واحدًا، وتزيد من اندفاع بن غفير وسموتريتش للعودة إلى غزة، وتحقق، في الوقت ذاته، مسعى بعض الأنظمة العربية لإغلاق ملف الفلسطينيين إلى الأبد، لكنها بالنسبة للفلسطينيين، نكبة مفتوحة، لا تضعهم إلا أمام خيارين: الموت أو الصمود، ولا ثالث لهما.
بعين الحقيقة، لم تقم الصهيونية إلا على التهجير، ولم تتخلّ عنه يومًا، ولطالما سعت إلى انتهاز الحرب والسلم معًا لتحفيزه والتأسيس له، فبالنسبة لقادتها، فإن نجاح التهجير يعني سيطرة يهودية كاملة على الأرض، مع وجود عربي ضئيل، صامت، مُنهك، لا يُشكّل عبئًا أمنيًا. أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن التهجير يفشل طالما بقي فلسطيني واحد على الأرض، ينهض من تحت الركام، ويصرخ باسم بلاده، ويُثبت وجوده.
وما بين هاتين المعادلتين، يظهر الخاسر بوضوح فاضح، ذلك الذي يُمنح فرصة تلو أخرى على حساب أجساد الفلسطينيين وأرواحهم، ليُنتزع له نصرٌ زائفٌ، مدعومٌ من الشرق والغرب، لكنه لا يصمد أمام عزيمة صاحب الأرض.
المصدر: نون بوست