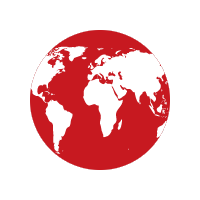في منتصف القرن التاسع عشر، كانت فلسطين جزءًا من إمبراطورية عثمانية إسلامية مترامية الأطراف، وامتدادًا جغرافيًا لمحيطٍ عربي يزخر بالعادات والتقاليد المتوارثة، التي تُضفي على كل موسم ديني واجتماعي ألوانه الخاصة، وتجعل منه امتيازًا قابلًا للتجدد والتكرار، مراتٍ ومرات.
وبرغم التفاوت الاجتماعي والديني والطبقي في البقعة نفسها، كانت الاحتفاليات غالبًا سائدة وعامة لمختلف أطياف الجمهور، حتى ممن لم يشملهم الطقس الاحتفالي؛ فشارك المسيحيون في إحياء المواسم الدينية الإسلامية، وانضم المسلمون إلى احتفالات المواسم المسيحية، كما اجتمعت الطوائف والأديان جميعًا في مواسم عامة جعلت من مواسم الحصاد والمطر وميلاد الأنبياء وهجراتهم احتفاليات أخرى، تُعزز وجود حياةٍ على تلك الأرض.
وينطبق ذلك على الأعياد الإسلامية، التي تطورت مظاهر الاحتفال بها وفقًا للنمطين العثماني؛ المرتبط باحتفالات إسطنبول وتبعية كل من متصرفية القدس ولواء نابلس وأعماله للإمبراطورية العثمانية، والنمط المصري؛ المرتبط بالامتداد العسكري وولاية الخديوي عباس حتى عام 1892.
ونتيجةً لذلك، ترك كلا النمطين بصمته وملامحه البارزة على احتفاء الفلسطينيين بأعيادهم حتى اليوم، مؤكدًا امتدادات جغرافية وديموغرافية وصلاتٍ تنفي الرواية الصهيونية عن “أرضٍ بلا شعب”، وتؤكد بأدلةٍ مصورة، بأيدي عربٍ وفلسطينيين وأجانب، وجود شعبٍ يموج بالحركة والتفاعل على أرضه، ويقتطع من كدّه وتعبه قليلًا من أجل متعة العيد وأجوائه.
من السنوات الأخيرة في العهد العثماني، إلى الانتداب البريطاني، فالنكبة وما بعدها، تفتح هذه المادة المصورة خزائن الذكريات لأرشيف أعيادٍ كثيرة عاشها الفلسطينيون الأوائل، حتى فلسطينيو اليوم، متأملة في ملامح جميلة لماضٍ انطفأ ولم يبقَ منه سوى غبار الصور.
العيد في العهد العثماني
بدأ الحُكم العثماني لفلسطين يتراجع تحت وقع الهجمات البريطانية مطلع عام 1917، وخلال ثلاثة أعوام استطاع البريطانيون بسط سيطرتهم على جميع مناطق فلسطين.
ومع حلول عام 1920، أعلنت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على البلاد، ورغم طول مدة العهد العثماني التي تجاوزت أربعة قرون، إلا أن الأرشيف المصوّر المرتبط بتلك الفترة يظل محدودًا مقارنةً بالفترات اللاحقة، نظرًا لتأخر اختراع آلة التصوير، وقلّة عدد المصوّرين العرب (معظمهم كانوا من الأرمن والطليان)، إلى جانب تجاهل المؤسسات العربية والفلسطينية لاحقًا لأرشيفها لصالح المؤسسات “الإسرائيلية” التي سارعت للاستحواذ عليه.
ومن بين أبرز المصوّرين في تلك الفترة كان اللبناني خليل رعد (1854 ـ 1957)، إلى جانب الأخوين جميل ألبينا (1898 ـ 1963) ونجيب ألبينا (1901 ـ 1983)، اللذين عملا في شبابهما ضمن دائرة التصوير التابعة للأمريكان كولوني، قبل أن يختفي أرشيف صورهما لاحقًا، كما هو حال معظم إرث المصوّر حنّا صافية (1910 ـ 1979)، والمصوّرة كريمة عبود (1893 ـ 1940)، التي نُسي اسمها ولم يُعد اكتشاف أعمالها إلا في عام 2000.
وتُظهر الصور القليلة المتوفرة عن العيد في فترة الحكم العثماني تركيزًا ملحوظًا على طقوسه في المدن الكبرى مثل يافا والقدس وأريحا، ويبدو أن الارتباط كان وثيقًا بين ارتفاع المستوى الاجتماعي والمعيشي للفلسطينيين في تلك المدن، وتنوع أدواتهم في التعبير عن فرحهم بالعيد وممارستهم لطقوسه.
ويلاحظ وجود توثيق متكرر للعيد في مدينة يافا، التي كانت أكبر مدينة فلسطينية قبل النكبة، ومركزًا ثقافيًا ونقطة التقاء للحركة التجارية الفلسطينية مع العالم، كما ساعدها موقعها على البحر الأبيض المتوسط لتكون بوابة فلسطين، وتحمل لقب “عروس البحر”.
المصدر: نون بوست